مراجعة كتاب "تاريخ موجز للزمان" للكاتب ستيفن هوكينج - المقالة 2
أصل ومصير الكون ... ميكانيكا الكم
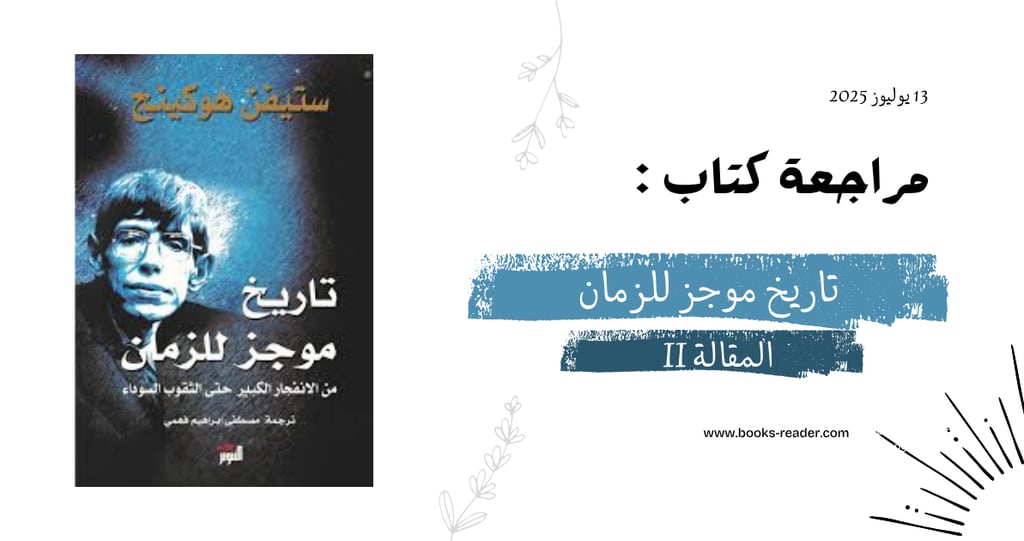

بعد رحلتنا عبر العصور لنعرف مختلف الأفكار عن المكان والزمان. رحلتنا لم تنتهي بعد فاليوم نصطحبكم في رحلة أخرى أعمق مما رأينا في مقالتنا الأولى. فاليوم سنتعرف على أصل الجسيمات والقوى في الطبيعة ولكن قبل ذلك سنلقي نظرة على ميكانيكا الكم ومبدأ الريبة لنحط الرحال في أصل الكون ونغوص في النظريات المختلفة حوله.
بعد إنتهائك من قراءة هذه المقالة سيتبقى لك مفهوم واحد عن الكون وهو الثقوب السوداء وهذا ما ستجده في المقالة الموالية بكل تفصيلة ذكرت في كتاب "تاريخ موجز للزمان". إربط الحزام ودعنا نبدأ ...
الفهرس :
- مبدأ الريبة ونظرية الكم
- الجسيمات الأولية وقوى الطبيعة
- أصل الكون
- تقييم قارئ الكتب
مبدأ الريبة ونظرية الكم :
سنة 1926 أثبت العالم فرنر هايزنبرغ أنه ليتنبأ المرء بموضع جسيم وسرعته في المستقبل يجب عليه أن يقيس سرعته وموضعه الحاليين بدقة وذلك بتسليط الضوء عليه، وقبل ذلك سنة 1900 أثبت العالم الألماني ماكس بلانك أن الضوء وأشعة X وبقية الموجات تبث في حزمات سماها "الكمات"، ولك كمه قدر من الطاقة تكون أكبر كلما ازداد تردد الموجة.
للحصول على موضع الجسيم الحالي ينبغي أن نضيء عليه بفوتونات ذات طول موجة صغيرة جدا، لكن المشكل هنا أن هذا النوع من الفوتونات يحمل معه طاقة كبيرة، عندما يصطدم الفوتون بالجسيم ينقل إليه طاقته، بالتالي فنحن نكون على علم بمكان الجسيم لكن سرعته واتجاه حركته سيتغير نتيجة للطاقة التي اكتسبها.
والعكس صحيح، إن استخدمنا موجات طويلة فسنعرف سرعته وحركته لأن الطاقة المنتقلة للجسيم لن تؤثر في ذلك، لكن موقعه لن يكون دقيقا. وهذا هو مبدأ الريبة، لا يمكن تحديد زوجين من الخصائص المترافقة لجسيم كمومي بدقة مطلقة وفي نفس الوقت، فكلما زادت دقة قياس إحدى الخاصيتين، قلت دقة قياس الخاصية الأخرى المقترنة بها.
هنا تتدخل ميكانيكا الكم، فهي تسمح بإدخال عنصر العشوائية أو عدم إمكان التنبؤ في النظريات العلمية فتسمح بالتنبؤ بالعديد من النتائج الممكنة ومدى احتمال كل واحدة منها بدل التركيز على نتيجة واحدة فقط ...
الجسيمات الأولية وقوى الطبيعة :
توجد نظريتان حاليا فيما يخص بداية الكون، الأولى جميعنا يعرفها وهي نظرية الانفجار العظيم أو "الانفجار الكبير الساخن"، أما الثانية فهي نظرية الانفجار العظيم التضخمي أو تفسير آلان غوث للكون.
نظرية الانفجار العظيم:
تفرض أن الكون قبل الانفجار بثوان كان كثيفا للغاية وساخنا جدا ما يمنع تفاعل الجسيمات مع بعضها، بعد الانفجار بثانية واحدة انخفضت درجة حرارة الكون لما يقارب 10 آلاف مليون درجة. مع استمرار تمدد الكون وبرودته تبدأ الجسيمات بالتفاعل مع بعضها البعض (خاصة الأزواج جسيم/ مضاد جسيم فيفني بعضها الآخر) فلا يتبقى منها إلا بعض الإلكترونات والنيوترونات.
تتحول بعض النيوترونات إلى بروتونات فينتج من بعضها ذرات الهيدروجين، بينما ربع البروتونات والنوترونات المتبقية تتحول إلى نوى هيليوم وقدر صغير من الهيدروجين الثقيل وعناصر أخرى. بعد مليون سنة من الانفجار العظيم مع استمرار تمدد الكون وبرودته تبدأ النويات والإلكترونات بالتفاعل مع بعضها مشكلة الذرات.
في بعض المناطق شديدة الكثافة تكون الجاذبية كافية لمنع تمددها، فتبدأ بالتقلص بينما تبدأ المادة الأولية المحيطة بهذه المناطق بالدوران من حولها مشكلة المجرات الدوارة أما المناطق الأخرى فهي تشكل المجرات الإهليجية.
إذ يمضي الوقت داخل المجرات، يبدأ غاز الهيدروجين والهيليوم بالتفكك إلى سحب أصغر تتقلص بتأثير جاذبيتها فتنكمش على نفسها، فتتفاعل الذرات داخل هذه السحب فتزداد حرارتها لتبدأ التفاعلات النووية الاندماجية التي تمنح القوة الكافية لإيقاف الانكماش، وهكذا تولد النجوم مثل شمسنا (التي تعتبر نجما من الجيل الثاني أو الثالث تكونت منذ ما يقارب 5 آلاف مليون سنة).
نشأة الأرض: الكواكب تتكون من العناصر التي تنتج عن انفجار النجوم الكبيرة، وهكذا تشكلت أرضنا بداية ككتلة صخرية ساخنة جدا دون أي غلاف جوي، ومع مرور الوقت بردت واكتسبت غلافا جويا من انبعاث الغاز من الصخور، لكنه لا يمكننا من البقاء فيه (لأنه يحتوي على مواد سامة للبشر ككبريتيد الهيدروجين)، لكن صور الحياة البدائية تتغذى على هذا الغاز منتجة الأكسجين، لما يغير من الغلاف الجوي ليصل إلى ما هو عليه اليوم، ليسمح بوجود الأشكال العليا للحياة كالأسماك، والثديات، والبشر.
نظرية آلان غوث للكون :
جاءت أساسا لتفسير بعض المشاكل التي كانت موجودة نتيجة الإنفجار العظيم ومبدأها أن الكون مباشرة بعد الإنفجار العظيم إستمر بالتمدد بشكل تضخمي وفق ثابتة كونية محددة ما يسمح ب :
· تفسير الشكل السطحي للزمان-المكان : فالتمدد التضخمي يجعل جميع نقط الزمان-المكان مسطحة كما هي عليه اليوم (الشيء الذي لا يمكن بلوغه بنظرية الإنفجار العظيم)
· حل مشكل التجانس : الإنفجار التضخمي هو الوحيد الذي يمكن أن يفسر التجانس الحراري في الخلفية الكونية الميكروية
· حل مشكلة المونوبول المغناطيسية : تفرض بعض قوانين الفيزياء نشوء جسيمات لها قطب مغناطيسي واحد وفق نظرية الإنفجار العظيم (سالب فقط أم موجب فقط) الشيء الذي لم يتم رصده قط. هنا النموذج التضخمي يسمح بتخفيف تأثير المونوبولا المغناطيسية لدرجة تسمح بعدم رصدها
يوجد إقتراح أخير مبني أساسا على مفاهيم فيزياء الكم وهو مقترح "هوكينج-هارتل" ومفاده أن الكون متناه في مداه لكن ليس له متفردة تشكل حدا له. أي أن الكون (الزمان-المكان) عبارة عن حلقة مرتبطة لا بداية لها ولا نهاية لها. فهي حلقة مغلقة تستمر في الوجود والدوران. وهكذا لا نهاية ولا بداية محددة للكون.
أصل الكون
تقييم قارئ الكتب :


شكرا لأخذك من وقتك الثمين و قراءة مراجعتنا للكتاب. نتمنى أن نكون عند حسن الظن. هل قرأت الكتاب من قبل ؟ ما تقييمك؟ لا نخفيكم أننا لسنا ذوي إختصاص فقد ننسى الإشارة لبعض الأفكار ربما لعدم فهمنا لها. إن كنت من الأخصائيين شاركنا رأيك و دعنا نتحاور في التعليقات.
ملاحظة :
- إن لم تقرأ الكتاب من قبل نشجعك على فعل ذلك. فقد يكون التلخيص مفيدا لكن غنى الكتاب بالمواقف الشخصية و التجارب الواقعية سيفيدك أكثر في سعيك لبلوغ الكفاءة الإنتاجية التي تطمح لها.
كان أرسطو يعتقد أن كل المادة في الطبيعة تنقسم إلى أربعة عناصر أساسية وهي التربة، الهواء، النار، والماء، على أن المادة متصلة، أي أنها لا تنقسم إلى "مادة" أصغر. أما القوى المتحكمة في المادة فاختزلهما في قوتين، الأولى هي الجاذبية، والثانية سماها "الخفة" وهي ما يجعل المادة تحلق عاليا (أي ضد الجاذبية).
بدأت فكرة الجزيئات مع ديموقريطس الذي قال إن المادة عبارة عن مجموعة متنوعة من الحبيبات المتصلة مع بعضها البعض، وأطلق على هذه الحبيبات اسم "ذرات". ليتم بعد ذلك إثبات هذه النظرية على يد الكيميائي والفيزيائي 'جون دالتون' سنة 1803 وأعاد أينشتاين إثباتها سنة 1905.
أما أول بنية للذرة فقد بدأت مع العالم 'ج. ج. تومسون' واستمرت في التطور لتصير ما نعرفه اليوم على يد العالم البريطاني 'روزرفورد أرنست' سنة 1911. أما نواة الذرة فقد طورت مع اكتشاف النيوترون على يد العالم 'جيمس شادويك' سنة 1932.
استمر العلم في التقدم حتى تم اكتشاف جسيمات صغيرة تدخل في تكوين البروتونات والإلكترونات وأطلق عليها اسم "الكواركات" على يد الفيزيائي 'موراي جيل مان'. واكتشف أن لها أنواعا مختلفة في الطبيعة:
· النكهات: توجد 6 أنواع مختلفة من الكواركات وهي: منخفض، عال، غريب، ساحر، قاع، قمة.
· الألوان: توجد 3 أنواع وهي أحمر، أخضر، أزرق.
اختلاف أنواع الكواركات هو ما يسمح باختلاف الجسيمات الناتجة عنها، فنجد مثلا:
- البروتون: يحوي كواركين من العالي + كوارك من المنخفض
- النيوترون: يحوي كواركين من المنخفض + كوارك من العالي
كل ما سبق ذكره فهو تحليل للمادة الموجودة في الطبيعة والكون أجمع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن في الكون الفسيح المادة (من الكواكب والنجوم إلى الكواركات) تعتبر جسيمات ذات لف ½، أما القوى المتحكمة فيها فهي تعتبر جسيمات لفها 0 أو 1 أو 2 وسنقوم بشرح الاختلاف بينهم حالا.
قوى الجاذبية:
قوة شاملة تأثر في أي جسم له كتلة أو طاقة، لكنها تعتبر أضعف القوى الأربع في الكون. يمكن إهمالها على المستوى الذري لكنها تغلب بقية القوى على مستوى المسافات الكبيرة. محمولة من طرف جسيم من لف 2 يسمى "جرافيتون" ليس له كتلة خاصة به، لدى القوة تستطيع التأثير في مسافات طويلة جدا.
القوى الكهرومغناطيسية:
تتفاعل مع الجسيمات المشحونة كهربائيا كالإلكترونات والكواركات، تعتبر أقوى كثيرا من الجاذبية، ناتجة عن جسيمات من لف 1 تسمى "فوتونات" لا كتلة لها.
القوى النووية الضعيفة:
المسؤولة عن النشاط الإشعاعي، ناتجة عن جسيمات من لف 1 تعرف باسم "بوزونات التوجه ذات الكتلة" إضافة إلى الفوتونات.
القوى النووية القوية:
مسؤولة عن إمساك البروتونات والنيوترونات في الذرة، وتمسك الكواركات في البروتونات والنيوترونات، ناتجة عن جسيم من لف 1 يسمى "الجليون" يتفاعل فقط مع نفسه أو مع الكواركات.
يعتقد أن كلا من القوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة ما هي إلا قوة واحدة في ظروف ذات طاقة مختلفة، وهذه نظرية 'واينبرج- سلام'. كما يعتقد أن القوة النووية القوية أيضا ما هي إلا اختلاف الطاقة للقوتين السابقتين وتسمى هذه النظرية ب 'النظرية الموحدة العظمى'.
وهكذا فكل القوى في الكون ما هي إلا قوة واحدة مع تعبير مختلف باختلاف الطاقة المحركة للقوة، باستثناء الجاذبية التي لا تزال العقبة نحو نظرية واحدة لتوحيد الفيزياء كما سنرى في المقالة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة © 2025
القائمة :
عن قارئ الكتب
